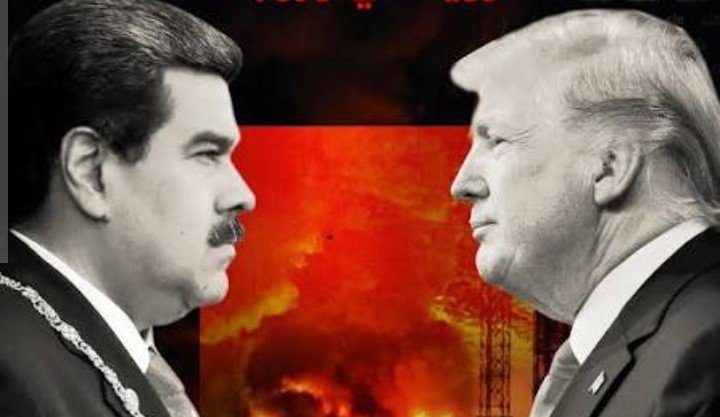كلاش بريس / الرباط
في الوقت الذي ضجّت فيه أبواق إعلامية جزائرية بما سمّته “استفزازاً خطيراً” بسبب توقيف شاب قليل الأدب تبوّل علناً في محيط ملعب، اختارت الآلة الرسمية نفسها الصمت أو التبرير حين تعلّق الأمر بجريمة أخطر وأفدح: مقتل ثلاثة شباب مغاربة برصاص البحرية الجزائرية، وجرح رابع، ثم احتجازهم لأشهر ورفض تسليم جثامين الضحايا لعائلاتهم.
أي ميزان هذا الذي يضخّم سلوكاً طائشاً إلى “قضية سيادية”، بينما يُخفَّف أو يُبرَّر قتل مدنيين عُزّل بدم بارد؟
المقارنة هنا ليست عبثية، بل كاشفة لمنطق مختلّ يحكم الخطاب والممارسة. فحين يكون الحدث بسيطاً، يُستدعى خطاب الكرامة الوطنية والعداء الخارجي، وحين تقع جريمة حقيقية، يُستحضر قاموس “الحدود” و“السيادة” و“التحقيقات الجارية” لإطفاء الغضب ودفن الحقيقة.
الأخطر من القتل نفسه هو ما تلاه: الاحتجاز المطوّل، الغموض المتعمَّد، ورفض تسليم الجثامين. هذه ليست أخطاء إجرائية، بل انتهاكات صريحة لأبسط الأعراف الإنسانية والقانونية. فحتى في النزاعات والحروب، تُصان كرامة الموتى، وتُسلَّم الجثامين، وتُحترم آلام العائلات. أما أن تتحول الجثث إلى أوراق ضغط صامتة، فذلك سقوط أخلاقي لا يمكن تلميعه بالشعارات.
ثم يأتي السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يُطلب من الرأي العام تصديق رواية “الانضباط والسيادة”، بينما تُدهَس قواعد العدالة والإنسانية؟ وكيف يُشيطَن شاب بسبب فعل مشين لكنه غير قاتل، في حين يُراد تطبيع إطلاق الرصاص على مدنيين بدعوى “الاشتباه”؟
إن المشكلة ليست في حادثة معزولة، بل في نظام خطاب وممارسة يرى في التهويل أداة، وفي الإنكار سياسة، وفي تأجيل الحقيقة أسلوب حكم. نظام يتغذّى على افتعال الخصومات الصغيرة ليصرف الأنظار عن الجرائم الكبيرة، ويستثمر في الإثارة بدل المحاسبة.
والتأكيد هنا واجب: النقد موجّه للنظام ومؤسساته، لا للشعب الجزائري الذي لا يقلّ ألماً ووعياً، والذي يدفع بدوره ثمن سياسات لا يقرّرها. فالشعوب لا تطلق الرصاص، ولا تحتجز الجثامين، ولا تكتب بيانات التبرير.
في النهاية، لا يمكن لمنطق سليم أن يساوي بين تبولٍ مستفزّ وجريمة قتل، ولا أن يقبل بتصنيف الأولى كتهديد وطني، وتبرير الثانية كإجراء سيادي…